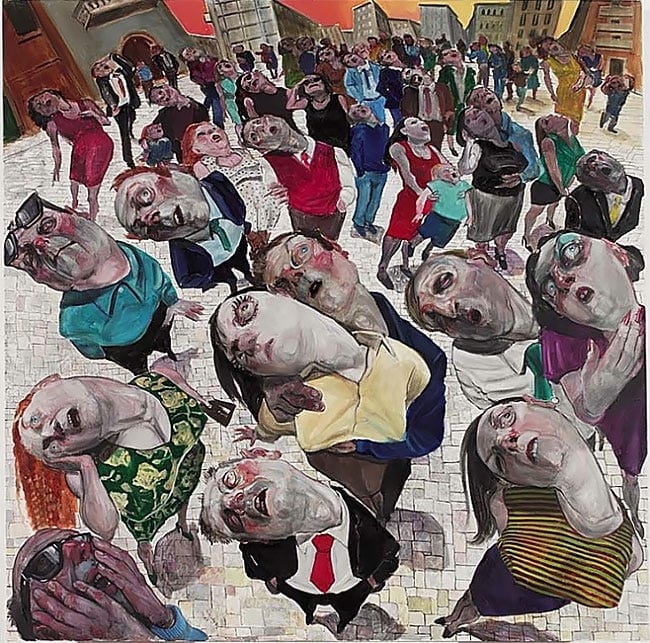دور السرديات الشخصية في صياغة المكان
منذ سقوط نظام الأسد في سوريا، سقطت معه “سوريا الأسد” ولاح في لغتنا اليومية مفهوم وليد عن واقع مختلف: “سوريا الجديدة”. المفهوم الذي اعتمدته جميع قنوات الإعلام التلفزية وقنوات السوشال ميديا، ليصبح مفهوماً واضحاً (بمعنى أنها سوريا ما بعد الأسد) وغير واضح (فما معنى أن تكون سوريا جديدة؟). وقد يكون من غير البديهي (أو غير المفيد للبعض) أن نسأل عن معنى سوريا الجديدة، وخصوصاً بعد أن كثرت فيديوهات السوشال الميديا التي تسأل المارّة في سوريا: “ماذا تغير عليكم بعد سقوط الأسد؟” وتطابقت تقريباً الإجابات ” كل شيء تغير، كل شي أحلى”. ولكن هل أصبح الناس في سوريا أخرى؟ وعن أي سوريا نتحدث؟ المكان؟ النظام الحاكم؟ الفكرة؟
من جهة أخرى، يكثر الحديث الإخباري والاجتماعي عن “الساحل” السوري، وفق مستويات خطاب مختلفة، فحيناً يتحول الساحل إلى طائفة دينية، وحيناً يتحول كدلالة لغوية بديلة لمفهوم فلول النظام البائد المجرم، وحيناً يصبح قاعدة عسكرية لتدخل خارجي، وحيناً مدخلاً إلى استقرار سوريا وسلمها الأهلي. فما هو الساحل؟ وما هي السردية التي ركبّت الساحل وما هي السردية التي ستفككه؟ (يمكن أيضاً استخدام هذه الأسئلة التحليلية في النظر إلى قسد والجزيرة السورية بكل المعاني المصنوعة لها)
أضيف إلى ذلك، استنهاض دمشق الأموية من كتب التاريخ، واستنطاق الصفة الأموية بمعانٍ سياسية لا طاقة لبني أميّة بها اليوم، فما معنى دمشق الأموية مكانياً وسياسياً وثقافياً؟ وأين تبدأ وتنتهي؟ مثلاً هل يجب أن نُقصي مشروع دمر، أو مخططات إيكو شار من دمشق الأموية؟ وهل يمكن أن نعتبر دمشق أيوبية؟ أو هيلينية؟
كل هذه الأسئلة تطرح علينا أهمية فهم معنى المكان والفضاء السوري (بجميع الأبعاد الجغرافية والتاريخية والاجتماعية والثقافية والسياسية) بالنسبة لنا كممارسين له. وهو ما ستحاول هذه المقالة التقديم له بالحديث عن مفهوم الفضاء الاجتماعي، وسرديات المكان، وما بينهما من جدليات قادرة على التدخل في الواقع، أو على صناعة واقع جديد، موازٍ أو متطابق مع الحياة اليومية، أي على التدخل فيما هو سياسي، وما هو دافع للتغيير.
الكلمة المنطوقة / المكان الذي نعيش فيه
حالها حال الكلمات في المعاجم، لا معنى أو دور أو غاية للأماكن في حال ظلّت في مخطط عمراني فقط، ولذلك فإنها تحتاج إلى سياق، وإلى متحدث ومستمع؛ فتتغير بتغير هذه العوامل. فإنّ الكرسي ذاته (بمعناه المعجمي) قد يقبع في بيت، أو في قصر، أو في معتقل، أو في مطار، (فماذا عن معناه الممارساتي؟) وبالتالي، فإنّ كل مكان بحاجة إلى الممارسة حتى يتحول إلى فضاء.
ولهذا فإننا لا نتحرك مثلاً في المدينة بكونها مكاناً، بل بكونها فضاءً اجتماعياً لعلاقات اجتماعية وسياسية وثقافية وغير ذلك. وبالتالي فإنّ الفضاء هو المكان الذي تحدث به الحياة[1]. ولكن ما أهمية أن يتحول المكان إلى فضاء؟ الأهمية تكمن في الممارسة فقط. الفضاء سيتحقق بوجود الحياة بدون شك، لكن ما يهمّنا هو أن ننتبه إلى أن أية ممارسة اجتماعية اليوم ستساهم في تشكيله غداً.
يعتقد هنري لوفيفر، صاحب أطروحة “إنتاج الفضاء” أنّ توليد (إنتاج) الفضاء الاجتماعي بالنسبة لمجتمع ما، يستطيع من خلاله أن يمثل نفسه، (حيث يتطابق الفضاء مع المجتمع)، ليس أمراً بسيطاً، بل إنه عملية معالجة مستمرة تحتاج الوقت[2]؛ عملية جدلية سياسية أيضاً بين مختلف العناصر المؤثرة في الفضاء العام (شعب + سلطة + جيوسياسة..الخ). بمعنى آخر، نحن لا نعيش في فضاء موجود مسبقًا، وإنما ننتجه من خلال الممارسات الاجتماعية (الأفعال اليومية)، وعلاقات القوة (السلطة، القطاع الخاص، مخططي المدن)، والأيديولوجيا (الأفكار السائدة، القيم الثقافية..الخ). وقد قدّم هنري لوفيفر لهذه العناصر المختلفة عبر مفهوم الثالوث المكاني، الذي يساعدنا في فهم تحولات المكان والمفاهيم المكانية في سوريا.
يتألف الثالوث المكاني، أولاً: من الممارسة المكانية؛ أي الفضاء المُدرَك (Perceived Space)، ويشير إلى فهمنا لأنماط الحياة اليومية وممارساتها. مثلاً أن نعرف أن الخطوط البيضاء في الشارع قرب إشارة المرور، هي لعبور الشارع حين تتوقف الإشارة، أو أن نفهم أن الرصيف للمشي، وأنه لا يمكن أن نرمي الأوساخ في الحديقة. بمعنى آخر، الفضاء المدرَك، هو الفضاء كما يجب استخدامه. أما ثانياً: فهو تمثّلات الفضاء؛ أي الفضاء المتصوَّر (Conceived Space) ويمثل الفضاء المفاهيمي التجريدي الذي خلقه مخططو المدن، أو السلطة التي صممته. مثلاً: يصمم المخطط (أو الدولة) مساحات عامة للناس كالحديقة للسيران ضمن تخطيطهم للمدن (لكن الناس قد تستخدم المساحة بطريقة مختلفة) وهو بالتالي الفضاء كما يتم التفكير فيه نظرياً. وأخيراً: لدينا الفضاء المتمثل؛ أي الفضاء المعاش (Lived Space) وهو فضاؤنا كممارسين، مشبعاً بالعاطفة والرمزية الشخصية والذاكرة، ويرتبط بذواتنا وباستخدامنا للمكان، وبالتالي فهو الفضاء كما يتم الشعور به، أو كما نريد أن نعيشه. فمثلاً، سيقطع الناس الشارع من أماكن مختلفة، أو سيذهبون في سيران على عشب طريق المطار (في دمشق) أو ساحة جامع خالد بن الوليد (في حمص)، وغيرها. وبالطبع فإن الفضاء الذي نعيش فيه، هو عبارة عن خليط كبير من هذا الثالوث من نتيجة تفاعلنا معه وجدالنا حوله. وبالتالي فهو حوار بين السلطة المعرفية (المخطط الهندسي) والسلطة السياسية (الحوكمة المكانية) والمستخدمين (الشعب).
هويّة المكان/ كأس ماء تحت حنفية
بالنسبة للجغرافية البريطانية دورين ماسي[3]، من الممكن فهم أيّ مكان من خلال العلاقات الاجتماعيّة فيه؛ أي من خلال التفاعل الاجتماعيّ والعلاقات السياسيّة القائمة في مجتمع هذا المكان. وليست هوية الأمكنة إلّا نتاجًا لموضَعة ومقارَبة وتشارك هذه العلاقات الاجتماعيّة في المكان المدروس. ولأنّ هذه العلاقات الاجتماعيّة (ستكون بشكل أو بآخر) تتغيّر باستمرار، فإنّنا يمكن أن نقول وبكلّ جرأة، إنّ هويّات الأماكن، هي هويّات متحرّكة، كهويّات المجتمعات البشريّة الّتي تسكن هذه الأماكن، وبالتالي، وكأنّ المكانَ كأسُ ماء مملوء وموضوع أسفل صنبور ماء؛ كلما فُتح الصنبور، تغيرت ماء الكأس. مثلاً يمكن أن تخرج المدينة المحتلّة من هويّة الاحتلال إلى هويّة فوق وطنيّة (سوريا بعد الانتداب)، ويمكن أن تخرج المدينة من هوية وطنية إلى هوية تاريخية (سوريا الأموية)، أو من ديناميّات اجتماعيّة إلى أخرى تغيّر وتعدّل من هويّتها بشكل لا يمكن توقّعه. لذلك تقول ماسي بكلّ جرأة: “إنّ هويّة أيّ مكان، بما في ذلك الّذي نسمّيه بيتًا، هي هويّة قابلة للطعن بطريقة أو بأخرى[4]“.
ما أهمية كل هذا ودوره في سوريا الجديدة؟
تساهم التغييرات البسيطة اليومية في ممارسات المكان، أو في ما يُسمح/ لا يُسمح لنا فعله فيه، تساهم في تغيير هوية المكان تدريجياً وبالتالي تغيير الفضاء المعاش بالنسبة لنا، وتغيير الفضاء الاجتماعي الذي نعيش به، وهو الفضاء الذي يستطيع أن يؤثر على توليد الأفكار في المجتمع والسياسة. وهو ما كان في سوريا السابقة، حيث عمل النظام البائد على مدى عقود في تخريب أو تعطيل مختلف الفضاءات العامة[5].
ولذلك، فإن بعض التغييرات البسيطة في الممارسات اليوم، تساهم بطريقة أو أخرى في التأثير على الفضاء العام. مثلاً فإن تغيير طبيعة الأذان في الجامع الأموي (إن حدث)، هو ليس تغييراً جمالياً، بل هو تغيير على مستوى الفضاء العام (أيديولوجي أو سياسي)، وكذلك فإن مرور سيارة دعوية، أو تغييرات ساحة عبد الله الجابري في حلب، ليست تغييرات أخلاقية/ جمالية، بل هي تغييرات قادرة على إعادة تعريف الفضاء العام والتأثير على المجتمع. لكنّ هذه التغييرات لا تتوقف على التغيير المادي، بل قد تكون في مستوى السرديات، أي على المستوى اللغوي. وهو ما رأيناه في دخول مصطلح “سوريا الجديدة” الذي بعث في قلوبنا الأمل وأعطانا مساحة للشعور في التغيير. ومن جهة ثانية، سهّل مصطلح فلول “الساحل” تغيير معنى المكان واستباح الحديث عنه بأشكال متعددة، لا يجب التهاون معها.
أدوات تقاوم / السرديات الذاتية في تخطيط الفضاء العام
كلّ كاتبٍ صانعُ خرائط[6]، حيث يتشكل النصّ المكتوب بالسرد ويقوم عليه وبه، ليصبح بذلك عالماً خاصاً يدخله القارئ أو الباحث ويمشي في أفكاره الشوارع وينتج منه مكاناً جديداً يعكس أو يوازي أو يقابل مكاناً جغرافياً أو تاريخياً. وهنا أستحضر مثلاً نصوص أي مؤرخ محترف أو هاوٍ، ودورها في فهمنا للمكان المدروس وسبل العيش فيه. بمعنى آخر، فإن كل كتابة هي إعادة إنتاج للمكان واستعادة له من أي سلطة قادرة على امتلاكه وحرمان الناس منه.
من هذه النقطة تصبح مشاهداتنا اليومية، أو ملاحظاتنا الممارساتية للعيش في سوريا، أدوات فعل سياسية، قادرة على صناعة التغيير والتأثير حتى ولو على صعيد الحوار الوطني القائم افتراضياً أو واقعياً، ومع كل نص جديد (سردية) عن سوريا (أو أي مكان فيه) هناك نص سيتشكل للمقاومة أو للتوضيح أو للتجسير بين جميع الأطراف، وسد الثغرات التي قد تنمو على أطراف السرديات الساعية للشقاق. وإنّ هذه السرديات مجتمعةً ومتفاعلةً مع بعضها ستساهم حتماً في “سوريا الجديدة” من خلال تفاعلها وجدلها في سبيل امتلاك الحق فيها.
فالحديث عن الحق في مدننا في سوريا لا يقل صعوبةً عن المجتمعات التي تقطنها وتعيش بداخلها؛ فليست المدينة، سوى رغبة الإنسان في إعادة تشكيل العالم (سياسياً ثقافياً واجتماعياً)، إنّها شكلُ الحياة التي نريد أن نعيش، وانعكاس لما نريد أن نصير، وإن كل محاولة جديدة لإنتاج المدينة، هي أيضاً إعادة إنتاج للإنسان الذي يعيشها. وبالتالي، فإن نوعيّة المدينة التي يريد الإنسان أن يسكنها، هي مسألة غير منفصلة عمّا يريد أن يكون، وعن أنواع العلاقات الاجتماعية وأنماط الحياة التي يسعى إليها، وعلاقتها بالمحيط البيئي وقيمها الجمالية[7].
ختاماً، أشير إلى تعريف المدينة حسب «معجم الدوحة التاريخيّ»: “المدينة: المِصرُ الجامع والمكان الكبير”؛ أي أنّها المكان القادر على جمع مجموعة من الناس، واحتواء سرديّات عديدة وكثيرة. ومن معاني كلمة المِصر أيضًا، أنّه الحدّ؛ وعليه فإنّ المدينة (كل مدينة ولا سيّما كل مدينة سوريّة) هي مجموعة أمصار مجتمعة؛ أي حدود مجتمعة؛ أي ذوات مجتمعة. تقوم على الاختلاف وتسعى إلى جمعه وتحديده.
[1] Michel De Certeau. trans. Steven Rendall, “The Practice of Everyday Life”, (University of California Press, Berkeley 1984). 124
[2] Henri Lefebvre. “The Production of Space”. (Oxford, England: Blackwell. 1991) 34.
[3] Doreen Massey, “Space, Place, and Gender”, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994).
[4] Ibid, 167-169.
[5] انظر: محمد جمال باروت، “العقد الأخير في تاريخ سورية جدلية الجمود والإصلاح”، (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات)، 2012.
[6] Robert T. Tally Jr. “Literary Cartographies: Spatiality, Representation and Narrative”, (NewYork, Palgrave Macmillan: 2014) 1.
[7] وهو ما يشير إليه السوسيولوجي المعماري روبرت بارك معرّفاً المدينة بكونها قيام الإنسان بإعادة إنتاج العالم وفقاً لأهوائه ورغباته. انظر:
David Harvey, The rebel cities from the right to the city to the urban revolution, New York: Verso, 2012